

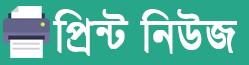
الوجع المكتوم: رمزية الألم والصمت في شعر حياة الرايس
الباحثة والناقدة: د/ آمال بوحرب – تونس
القراءة الفنية
الغربة والصمت في مواجهة العزلة والضياع
هل يمكن للإنسان أن يواجه ألمه الداخلي دون أن يفقد نفسه؟ كان هذا السؤال وما زال محورًا أساسيًا في الأدب والفلسفة، حيث يُنظر إلى الألم ليس فقط كمعاناة شخصية، بل كقوة دافعة لإعادة اكتشاف الذات. في الأدب، يستخدم الشعراء والروائيون الرموز والأساطير للتعبير عن الألم بأشكال تتجاوز حدود اللغة العادية، بينما في الفلسفة يُطرح الألم كتجربة وجودية تجبر الإنسان على مواجهة حقيقته العميقة يرى نيتشه أن الألم هو الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى القوة والتحول، إذ يقول: “ما لا يقتلني يجعلني أقوى” أما فرويد، فيرى أن الألم المكبوت يعيد تشكيل نفسه في اللاوعي، مؤثرًا في طريقة تعامل الإنسان مع العالم. لكن ماذا يحدث عندما يصبح الألم أكبر من قدرة الإنسان على فهمه؟ هل يتحول إلى صمت أم إلى صراع داخلي لا نهاية له؟و في هذا السياق، شدت انتباهي قصيدة الكاتبة والشاعرة حياة الرايس، فأردت أن أتأمل أبعادها الوجودية والجمالية من خلال جدلية العلاقة بين الصمت والرمز في البناء الشعري.
تقول الشاعرة
هجمة الحياة عليّ…
هذا الصّباح
كنتَ هجمة الحياة عليّ.
وقد كنت أظنني عندكَ نسيا منسيا.
فارتبكتُ واختفيتُ
كطفلة فاجأها العيد على حين غفلة
أنا الصائمة عشرة أهلّة
عمر صمتك المبيّت.
أربكني العيد.
ولا شرائط في شعري
ولا ألوان في فستاني…
من أين يأتي العيد؟
وانت مفارق بعيد5
! يا لقلب الطفلة
!– “مكسور قلبي يا عشتار” صرخت
فما استجابت عشتار.
كانت مثلي تكابد هجر تموز.
يا ربّ الذكور:
أعد لي تموز وانا أصلي لك ليلا نهارا
قال ربّ الذكور وقد استوى على عرشه:
ش” ذاك هو تموز بعيد بعييييد… حتّى يدي لا تطالُه.
جالس هناك، على سدرة المنتهى، في حلّته الطقوسيّة، يعزف الناي لامرأة غيرك.
فلا تزعجيه فهو تحت رعايتي “
ور فع يدَه يباركه.
! يا لقلب المرأة
من يطفئ حرائق الغيرة؟
وكعذراء المعبد (وما انا بقدّيسة)
أقمت كرها لا طوعا طقوس الصّمت الجنائزي
عشرة أهلّة كاملة.
والبخور يخنقني ويكتم أنفاسي والنار تلتهم طرف ثوبي وتأتي على جسدي…
ما أصعب ان نحّب في صمت
ان نجّن في صمت
ان نموت في صمت…
حياة الرايس شاعرة وروائية تونسية تعيش بسويسرا
1-الصمت الجنائزي: العجز عن التعبير والموت الداخلي
يشكل الصمت محورًا أساسيًا في القصيدة، حيث تصفه الشاعرة بأنه “صمت جنائزي” يمتد لعشرة أهلة،فلا يعكس فقط غياب الكلمات، بل غياب الحياة ذاتها وفي الفلسفة، يرتبط الصمت بفكرة العجز عن التعبير عن المشاعر العميقة، وهو ما أشار إليه هايدغر حين قال “إن الصمت قد يكون أحيانًا أكثر بلاغة من الكلام “فيصبح حالة من القمع العاطفي والاغتراب الداخلي
وقد كان الصمت موضوعًا للعديد من التأملات العميقة الفيلسوف لودفيغ فيتجنشتاين، في كتابه “الرسالة الفلسفية”، قال: “ما لا يمكن التحدث عنه، يجب السكوت عنه” مؤكدًا أن هناك حدودًا للغة في التعبير عن الحقائق العميقة وهذا الصمت ليس غيابًا للكلام، بل هو اعتراف بوجود ما يتجاوز اللغة أما بالنسبة للفيلسوف الصوفي الياباني د.ت. سوزوكي رأى أن الصمت هو اللغة الحقيقية للروح، حيث تتوقف الكلمات عن التعبير ويبدأ الفهم العميق في الثقافة الصوفية، إذ هو وسيلة للاتصال بالذات الإلهية، حيث تتلاشى الحواجز بين الإنسان والكون وفي المقابل، الفيلسوف الفرنسي موريس بلانشو تحدث عن الصمت كتجربة وجودية، حيث يصبح الإنسان واجهة للفراغ والغياب في كتابه “الفضاء الأدبي”، يرى بلانشو أن الصمت هو المكان الذي يلتقي فيه الإنسان بحقيقته العميقة، بعيدًا عن ضجيج العالم الخارجي تجارب مؤلمة ولها أبعاد تتعلق بالحركة والسكون لا تستطيع الكلمات تحقيقها…
2-الغيرة والحب المفقود صراع بين الرغبة والخوف:
تبرز الغيرة كمظهر آخر من مظاهر الألم العاطفي، خاصة حين تتحدث الشاعرة عن تموز، الإله السومري الذي يعزف الناي لامرأة أخرى، مما يعكس صراعًا داخليًا بين الرغبة في الحب والخوف من فقدانه أفلاطون رأى أن الحب هو البحث عن النصف الآخر الذي يكملنا، لكن في هذه الحالة، تشعر الشاعرة أنها فقدت هذا النصف، مما يجعل الغيرة تنبع من خوفها من أن تكون غير مرئية أو مستبدلة وهذا الشعور يضعها في مواجهة حتمية مع الفقدان، حيث يصبح الحب ذاته مصدرًا للألم.
ولعل هذا الموقف يذكرنا بالفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، في كتابه “انفعالات النفس”، تحدث عن الغيرة كشعور مركب يجمع بين الحب والخوف وفقًا لديكارت، الغيرة هي نتاج الخوف من فقدان الحبيب لصالح شخص آخر، فكرة يجعلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحب والرغبة في الاحتفاظ به في حين أن فريدريك نيتشه، فقد رأى في الغيرة قوة دافعة للتغيير والتحول. في كتابه “هكذا تكلم زرادشت”، قال نيتشه: “الغيرة هي الشرارة التي تشعل النار في الروح”، مؤكدًا أن الغيرة يمكن أن تكون مصدرًا للإبداع والتفوق إذا تم تحويلها إلى طاقة إيجابية.
3-الرموز الدينية والأسطورية: دورة الحياة والموت
تتشابك القصيدة مع الرموز الدينية والأسطورية، خاصة من خلال شخصيتي تموز وعشتار، اللذين يجسدان دورة الحياة والموت في الأساطير السومرية. تضفي هذه الرموز على القصيدة بعدًا فلسفيًا يعكس الصراع الدائم بين الأمل واليأس، بين الخصب والجفاف، بين البعث والموت. في الفلسفة، يمكن النظر إلى هذه الرموز باعتبارها محاولات لتفسير طبيعة الفقدان والتجدد، حيث يصبح الحزن نفسه طقسًا يعيد تعريف الهوية الإنسانية. الطقوس الجنائزية التي تصورها الشاعرة ليست مجرد وداع للحبيب، بل محاولة لإيجاد معنى في فقدانه، رغم إدراكها أن هذا المعنى قد يكون مراوغًا أو حتى غير موجود.
3-الموت في الصمت: فقدان المعنى والغاية
في نهاية القصيدة، يأخذ الصمت بعدًا أكثر حدة، حيث يصبح مرادفًا للموت وليس مجرد نهاية جسدية، بل هو تعبير عن فقدان القدرة على الشعور والمعنى ولقد تحدث كيركغور عن “الموت الوجودي”، حيث يفقد الإنسان غايته في الحياة قبل أن يموت فعليً